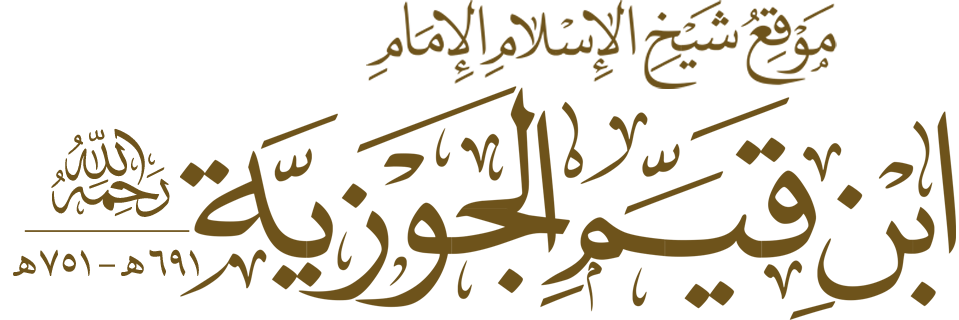حكمه صلى الله عليه وسلم في النفقة على الزوجات وأنَّه لم يُقدِّرها، ولا ورد عنه ما يدلُّ على تقديرها، وإنَّما ردَّ الأزواج فيها إلى العرف.
ثبت عنه في «صحيح مسلم» أنَّه قال في خطبة حجَّة الوداع بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته ببضعةٍ وثمانين يومًا: «واتُّقوا الله في النِّساء، فإنَّكم أخذتموهنَّ بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجَهنَّ بكلمة اللَّه، ولهنَّ عليكم رِزقُهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف».
وثبت عنه في «الصَّحيحين» أنَّ هندًا امرأة أبي سفيان قالت له: إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، ليس يعطيني من النَّفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فقال: «خُذِي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف».
وفي «سنن أبي داود» من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه قال: أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول اللَّه، ما تقول في نسائنا؟ قال: «أَطعِموهنَّ ممَّا تأكلون، واكْسُوهنَّ ممَّا تلبسون، ولا تضربوهنَّ ولا تُقبِّحوهنَّ».
وهذا الحكم من النبي - صلى الله عليه وسلم - مطابقٌ لكتاب الله عزَّ وجلَّ، حيث يقول تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]. والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - جعل نفقة المرأة مثل نفقة الخادم، وسوَّى بينهما في عدم التَّقدير، وردَّهما إلى العُرف فقال: «للمملوك طعامُه وكسوتُه بالمعروف»، فجعل نفقتهما بالمعروف، ولا ريبَ أنَّ نفقة الخادم غير مقدَّرةٍ، ولم يقل أحدٌ بتقديرها.
وصحَّ عنه في الرَّقيق أنَّه قال: «أَطعِموهم ممَّا تأكلون، وأَلبِسوهم ممَّا تلبسون»، رواه مسلم، كما قال في الزَّوجة سواءٌ.
وصحَّ عن أبي هريرة أنَّه قال: امرأتك تقول: إمَّا أن تُطعِمني وإمَّا أن تُطلِّقني، ويقول العبد: أَطعِمْني واستعمِلْني. ويقول الابن: أَطعِمْني، إلى من تَدَعُني؟. فجعل نفقة الزَّوجة والرَّقيق والولد كلَّها الإطعامَ لا التَّمليكَ.
وروى النَّسائيُّ هذا مرفوعًا إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي.
وقال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89]، وصحَّ عن ابن عبَّاسٍ أنَّه قال: الخبز والزَّيت. وصحَّ عن عمر بن الخطاب: الخبز والسَّمن، والخبز والتَّمر، ومن أفضل ما تطعمون الخبز واللَّحم.
ففسَّر الصَّحابة إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأُدْم، والله ورسوله ذكرا الإنفاق مطلقًا من غير تحديدٍ ولا تقديرٍ ولا تقييدٍ، فوجب ردُّه إلى العرف لو لم يردَّه إليه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فكيف وهو الذي ردَّ ذلك إلى العرف، وأرشد أمَّته إليه؟ ومن المعلوم أنَّ أهل العرف إنَّما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم، حتَّى من يوجب التَّقدير الخبزَ والأُدْم دون الحَبِّ، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إنَّما كانوا ينفقون على أزواجهم كذلك دون تمليكِ الحَبِّ وتقديرِه؛ ولأنَّها نفقةٌ واجبةٌ بالشَّرع، فلم تتقدَّرْ بالحبِّ كنفقة الرَّقيق، ولو كانت مقدَّرةً لأمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هندًا أن تأخذ المقدَّر لها شرعًا، ولَمَا أمرها أن تأخذ ما يكفيها من غير تقديرٍ وردَّ الاجتهاد في ذلك إليها.
ومن المعلوم أنَّ قدر كفايتها لا ينحصر في مُدَّينِ ولا في رِطلين، بحيث لا يزيد عليهما ولا ينقص، ولفظه لم يدلَّ على ذلك بوجهٍ ولا إيماءٍ ولا إشارةٍ، وإيجابُ مُدَّين أو رِطلين خبزًا قد يكون أقلَّ من الكفاية، فيكون تركًا للمعروف، وإيجاب قدر الكفاية ممَّا يأكل الرَّجل وولدُه ورقيقُه وإن كان أقلَّ من مدٍّ أو من رِطلَيْ خبزٍ إنفاقٌ بالمعروف، فيكون هو الواجب بالكتاب والسُّنَّة. ولأنَّ الحَبَّ يحتاج إلى طحنه وخبزه وتوابع ذلك، فإن أخرجتْ ذلك من مالها لم تحصل الكفايةُ بنفقة الزَّوج، وإن فُرِض ذلك لها عليه من ماله كان الواجب حَبًّا ودراهم، ولو طلبتْ مكانَ الخبز دراهمَ أو حَبًّا أو دقيقًا أو غيره لم يلزمه بذلُه، ولو عرض عليها ذلك أيضًا لم يلزمها قبولُه؛ لأنَّ ذلك معاوضةٌ، فلا يُجبر أحدهما على قبولها، ويجوز تراضيهما بما اتَّفقا عليه.
والَّذين قدَّروا النَّفقة اختلفوا، فمنهم من قدَّرها بالحبِّ، وهو الشَّافعيُّ، فقال: نفقة الفقير مدٌّ بمدِّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ أقلَّ ما يُدفع في الكفَّارة إلى الواحد مدٌّ، والله سبحانه اعتبر الكفَّارة بالنَّفقة على الأهل، فقال: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89]، قال: وعلى الموسر مُدَّانِ؛ لأنَّ أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مدَّينِ في كفَّارة الأذى، وعلى المتوسِّط مدٌّ ونصفٌ، نصفُ نفقةِ الموسر، ونصف نفقة الفقير.
وقال القاضي أبو يعلى: هي مقدَّرةٌ بمقدارٍ لا يختلف في الكثرة والقلَّة، والواجب رِطلانِ من الخبز في كلِّ يومٍ في حقِّ الموسر والمعسر اعتبارًا بالكفَّارات، وإنَّما يختلفان في صفته وجودته؛ لأنَّ الموسر والمعسر سواءٌ في قدر المأكول وما تقوم به البنيةُ، وإنَّما يختلفان في جودته، فكذلك النَّفقة الواجبة.
والجمهور قالوا: لا يُحفظ عن أحدٍ من الصَّحابة قطُّ تقديرُ النَّفقة، لا بمُدٍّ ولا برِطلٍ، والمحفوظ عنهم بل الذي اتَّصل به العمل في كلِّ عصرٍ ومصرٍ ما ذكرناه.
قالوا: ومن الذي سلَّم لكم التَّقديرَ بالمدِّ والرِّطل في الكفَّارة؟ والَّذي دلَّ عليه القرآن والسُّنَّة أنَّ الواجب في الكفَّارة الإطعامُ فقط لا التَّمليك، قال تعالى في كفَّارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89]، وقال في كفَّارة الظِّهار: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4]، وقال في فدية الأذى: {رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]. وليس في القرآن في إطعام الكفَّارات غيرُ هذا، وليس في موضعٍ واحدٍ منها تقديرُ ذلك بمدٍّ ولا رِطلٍ، وصحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال لمن وطئ في نهار رمضان: «أَطعِمْ ستِّين مسكينًا»، وكذلك قال للمُظاهِر، ولم يحدَّ ذلك بمدٍّ ولا رطلٍ.
فالَّذي دلَّ عليه القرآن والسُّنَّة أنَّ الواجب في الكفَّارات والنَّفقات هو الإطعام لا التَّمليك، وهذا هو الثَّابت عن الصَّحابة -رضي الله عنهم -.
قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: يُغدِّيهم ويُعشِّيهم خبزًا وزيتًا.
وقال أبو إسحاق عن الحارث: كان علي يقول في إطعام المساكين في كفَّارة اليمين: يُغدِّيهم ويُعشِّيهم خبزًا وزيتًا، خبزًا وسَمْنًا.
وقال ابن أبي شيبة: ثنا يحيى بن يعلى، عن ليث قال: كان عبد الله بن مسعودٍ يقول: {مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ} [المائدة: 89] قال: الخبز والسَّمْن، والخبز باللحم، والخبز بالزيت.
وصحَّ عن ابن عمر قال: أوسطُ ما يُطعِم الرَّجل أهلَه الخبز واللَّبن، والخبز والزَّيت، والخبز والسَّمْن، ومن أفضل ما يُطعِمهم الخبز واللَّحم.
وقال يزيد بن زُريعٍ: حدَّثنا يونس، عن محمَّد بن سيرين، أنَّ الأشعريَّ كفَّر عن يمينٍ له مرَّةً، فأمر بُجيرًا أو جُبيرا يُطعِم عنه عشرةَ مساكين خبزًا ولحمًا، وأمر لهم بثوبٍ معقَّدٍ أو ظهرانيٍّ.
وقال ابن أبي شيبة: ثنا يحيى بن إسحاق، ثنا يحيى بن أيوب، عن حميد، أنَّ أنسًا مرِض قبل أن يموت، فلم يستطع أن يصوم، فكان يجمع ثلاثين مسكينًا فيُطعِمهم خبزًا ولحمًا أكلةً واحدةً.
وأمَّا التَّابعون، فثبت ذلك عن الأسود بن يزيد، وأبي رَزِين، وعَبِيدة، ومحمَّد بن سيرين، والحسن البصريِّ، وسعيد بن جبيرٍ، وشُريح، وجابر بن زيدٍ، وطاوس، والشَّعبيِّ، وابن بُريدة، والضحّاك، والقاسم، وسالم، ومحمد بن إبراهيم، ومحمَّد بن كعبٍ، وقتادة، وإبراهيم النَّخعيِّ. والأسانيد عنهم بذلك في «أحكام القرآن»
لإسماعيل بن إسحاق، منهم من يقول: يُغدِّي المساكين ويُعشِّيهم. ومنهم من يقول: أكلةً واحدةً. ومنهم من يقول: خبزًا ولحمًا، خبزًا وزيتًا، خبزًا وسَمْنًا. وهذا مذهب أهل المدينة، وأهل العراق، وأحمد في إحدى الرِّوايتين عنه، والرِّواية الأخرى: أنَّ طعام الكفَّارة مقدَّرٌ دون نفقة الزَّوجات.
فالأقوال ثلاثةٌ: التَّقدير فيهما كقول الشَّافعيِّ وحده، وعدم التَّقدير فيهما كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الرِّوايتين، والتَّقدير في الكفَّارة دون النَّفقة كالرِّواية الأخرى عنه.
قال مَن نصر هذا القول: الفرق بين النَّفقة والكفَّارة أنَّ الكفَّارة لا تختلف باليسار والإعسار، ولا هي مقدَّرةٌ بالكفاية، ولا أوجبها الشَّارع بالمعروف كنفقة الزَّوجة والخادم، والإطعام فيها حقٌّ لله تعالى، لا لآدميٍّ معيَّنٍ فيرضى بالعوض عنه؛ ولهذا لو أخرج القيمة لم يُجزِئه. وروي التَّقدير فيها عن الصَّحابة، فقال القاضي إسماعيل: حدَّثنا حجَّاج بن المنهال، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن أبي وائل، عن يسار بن نمير قال: قال عمر: إنَّ ناسًا يأتوني يسألوني، فأحلف أنِّي لا أعطيهم، ثمَّ يبدو لي أن أُعطِيهم، فإذا أمرتُك أن تُكفِّر عنّي فأطعِمْ عنِّي عشرة مساكين، لكلِّ مسكينٍ صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعٍ من برٍّ.
حدَّثنا حجَّاج بن المنهال وسليمان بن حربٍ قالا: حدَّثنا حمَّاد بن سلمة، عن سلمة بن كُهيلٍ، عن يحيى بن عبَّاد، أنَّ عمر بن الخطَّاب قال: يا يَرْفَأ، إذا حلفتُ فحَنِثْتُ، فأَطعِمْ عنِّي ليميني خمسةَ أصواعٍ عشرة مساكين.
وقال ابن أبي شيبة: ثنا وكيعٌ، عن ابن أبي ليلى، عن عَمرو بن مُرّة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: كفَّارة اليمين إطعامُ عشرة مساكين، لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ.
حدَّثنا عبد الرحيم وأبو خالدٍ الأحمر، عن حجَّاج، عن قرط، عن جدَّته عن عائشة قالت: إنَّا نُطعِم نصفَ صاعٍ من برٍّ، أو صاعًا من تمرٍ في كفَّارة اليمين.
وقال إسماعيل: ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام بن أبي عبد اللَّه، ثنا يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة، عن زيد بن ثابتٍ قال: يجزئ في كفَّارة اليمين لكلِّ مسكينٍ مدُّ حنطةٍ.
ثنا سليمان بن حربٍ، ثنا حمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أنَّ ابن عمر كان إذا ذكر اليمين أعتقَ، وإذا لم يذكرها أطعم عشرة مساكين، لكلِّ مسكينٍ مدٌّ مدٌّ.
وصحَّ عن ابن عبَّاسٍ: في كفَّارة اليمين مُدٌّ، ومعه أُدْمُه.
وأمَّا التَّابعون فثبت ذلك عن سعيد بن المسيَّب، وسعيد بن جبيرٍ، ومجاهد، وقال: كلُّ طعامٍ ذُكِر في القرآن للمساكين فهو نصف صاعٍ، وكان يقول في كفَّارة الأيمان كلِّها: مُدَّانِ لكلِّ مسكينٍ.
وقال حمَّاد بن زيدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سليمان بن يسارٍ: أدركت النَّاس وهم يعطون في كفَّارة اليمين مدًّا بالمدِّ الأوَّل.
وقال القاسم وسالم وأبو سلمة: مدٌّ مدٌّ من برٍّ.
وقال عطاء: فرقًا بين عشرةٍ. ومرَّةً قال: مدٌّ مدٌّ.
قالوا: وقد ثبت في «الصَّحيحين» أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لكعب بن عُجْرة في كفَّارة فدية الأذى: «أَطعِمْ ستَّةَ مساكين نصفَ صاعٍ نصف صاعٍ طعامًا لكلِّ مسكينٍ». فقدَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدية الأذى، فجعلنا تقديرها أصلًا، وعَدَّيناه إلى سائر الكفَّارات.
ثمَّ قال من قدَّر طعامَ الزَّوجة: ثمَّ رأينا النَّفقات والكفَّارات قد اشتركا في الوجوب، فاعتبرنا إطعام النَّفقة بإطعام الكفَّارة، ورأينا الله سبحانه قد قال في جزاء الصَّيد: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ} [المائدة: 95]، وأجمعت الأمَّة أنَّ الطَّعام مقدَّرٌ فيها، ولهذا لو عُدِمَ الطَّعام صام عن كلِّ مدٍّ يومًا، كما أفتى به ابن عبَّاسٍ والنَّاس بعده. فهذا ما احتجَّت به هذه الطَّائفة على تقدير طعام الكفَّارة.
قال الآخرون: لا حجَّةَ في أحدٍ دون الله ورسوله وإجماع الأمَّة، وقد أمرنا تعالى أن نردَّ ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله، وذلك خيرٌ لنا حالًا وعاقبةً، ورأينا الله سبحانه إنَّما قال في الكفَّارة: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ} [المائدة: 89]، و {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4]، فعلَّق الأمر بالمصدر الذي هو الإطعام، ولم يَحُدَّ لنا جنسَ الطَّعام ولا قدْرَه، وحدَّ لنا جنس المُطْعَمين وقدْرَهم، فأطلق الطَّعام وقيَّد المطعومين. ورأيناه سبحانه حيث ذكر إطعام المسكين في كتابه، فإنَّما أراد به الإطعام المعهود المتعارف، كقوله تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا} [البلد: 12 - 15]. وقال: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8]. وكان من المعلوم يقينًا أنَّهم لو غَدَّوهم أو عَشَّوهم، أو أطعموهم خبزًا ولحمًا، أو خبزًا ومَرَقًا ونحوه= لكانوا ممدوحين داخلين فيمن أثنى عليهم. وهو سبحانه عَدَلَ عن الطَّعام الذي هو اسمٌ للمأكول إلى الإطعام الذي هو مصدرٌ صريحٌ، وهذا نصٌّ في أنَّه إذا أطعم المساكين ولم يُمَلِّكهم فقد امتثل ما أُمِر به، وصحَّ في كلِّ لغةٍ وعرفٍ: أنَّه أطعمهم.
قالوا: وفي أيِّ لغةٍ لا يَصدُق لفظ الإطعام إلا بالتَّمليك؟ ولمَّا قال أنس: إنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أطعم الصَّحابة في وليمة زينبَ خبزًا ولحمًا، كان قد اتَّخذ طعامًا ودعاهم إليه على عادة الولائم، وكذلك قوله في وليمة صفية: أَطعَمَهم حَيْسًا، وهذا أظهر من أن نذكر شواهده.
قالوا: وقد زاد ذلك إيضاحًا وبيانًا بقوله: {مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ} [المائدة: 89]، ومعلومٌ يقينًا أنَّ الرَّجل إنَّما يُطعِم أهلَه الخبزَ واللَّحم والمَرَق واللَّبنَ ونحو ذلك، فإذا أطعم المساكينَ من ذلك فقد أطعمهم من أوسط ما يُطعِم أهلَه بلا شكٍّ، ولهذا اتَّفق الصَّحابة في طعام الأهل على أنَّه غير مقدَّرٍ كما تقدَّم، والله سبحانه جعله أصلًا لطعام الكفَّارة، فدلَّ بطريق الأولى على أنَّ طعام الكفَّارة غير مقدَّرٍ.
وأمَّا من قدَّر طعام الأهل فإنَّما أخذ من تقدير طعام الكفَّارة، فيقال: هذا خلاف مقتضى النَّصِّ، فإنَّ الله أطلق طعام الأهل وجعله أصلًا لطعام الكفَّارة، فعُلِم أنَّ طعام الكفَّارة لا يتقدَّر كما لا يتقدَّر أصلُه، ولا يُعرَف عن صحابيٍّ البتَّة تقديرُ طعام الزَّوجة مع عموم هذه الواقعة في كلِّ وقتٍ.
قالوا: فأمَّا الفروق الَّتي ذكرتموها فليس فيها ما يستلزم تقديرَ طعام الكفَّارة، وحاصلها خمسة فروقٍ: أنَّها لا تختلف باليسار والإعسار، وأنَّها لا تتقدَّر بالكفاية، ولا أوجبها الشَّارع بالمعروف، ولا يجوز إخراج العوض عنها، وهي حقٌّ لله لا تَسقُط بالإسقاط بخلاف نفقة الزَّوجة.
فيقال: نعم لا شكَّ في صحَّة هذه الفروق، ولكن من أين يستلزم وجوبَ تقديرها بمدٍّ ومدَّين؟ بل هي إطعامٌ واجبٌ من جنس ما يطعم أهله، ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدلُّ على تقديرها بوجهٍ.
وأمَّا ما ذكرتم عن الصَّحابة من تقديرها، فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنَّا قد ذكرنا عن جماعةٍ ــ منهم علي وأنس وأبو موسى وابن مسعودٍ ــ أنَّهم قالوا: يُجزِئ أن يُغدِّيهم ويُعشِّيهم.
الثَّاني: أنَّ من رُوِي عنهم المدُّ والمدَّان لم يذكروا ذلك تقديرًا وتحديدًا، بل تمثيلًا، فإنَّ منهم من رُوي عنه المدُّ، ورُوي عنه مدَّان، وروي عنه مَكُّوكٌ، وروي عنه جواز التَّغدية أو التَّعشية، وروي عنه أَكْلةٌ، وروي عنه رغيفٌ أو رغيفين، فإن كان هذا اختلافًا فلا حجَّة فيه، وإن كان بحسب حال المستفتي وبحسب حال الحالف والمكفِّر فظاهرٌ، وإن كان ذلك على سبيل التَّمثيل فكذلك. فعلى كلِّ تقديرٍ لا حجَّة فيه على التَّقديرين.
قالوا: وأمَّا الإطعام في فدية الأذى فليس من هذا الباب؛ فإنَّ الله سبحانه قال: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، والله سبحانه أطلق هذه الثَّلاثة ولم يُقيِّدها. وصحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تقييد الصِّيام بثلاثة أيَّامٍ، وتقييد النُّسك بذبح شاةٍ، وتقييد الإطعام بستَّة مساكين لكلِّ مسكينٍ نصف صاعٍ، ولم يقل سبحانه في فدية الأذى: فإطعام ستَّة مساكين، ولكن أوجب صدقةً مطلقةً وصومًا مطلقًا ودمًا مطلقًا، فعيَّنه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالفَرق والثَّلاثة الأيَّام والشَّاة.
وأمَّا جزاء الصَّيد فإنَّه من غير هذا الباب، فإنَّ المُخرِج إنَّما يُخرِج قيمة الصَّيد من الطَّعام، وهي تختلف بالقلَّة والكثرة، فإنَّها بدلُ مُتْلَفٍ، ولا يُنظَر فيها إلى عدد المساكين، وإنَّما يُنظَر فيها إلى مبلغ الطَّعام، فيُطعِمه المساكينَ على ما يرى من إطعامهم وتفضيل بعضهم على بعضٍ، فتقدير الطَّعام فيها على حسب المُتْلَف، وهو يقلُّ ويكثر، وليس ما يُعطاه كلُّ مسكينٍ مقدَّرًا.
ثمَّ إنَّ التَّقدير بالحبِّ يستلزم أمرًا باطلًا بيِّنَ البطلان، فإنَّه إذا كان الواجب لها عليه شرعًا الحبَّ، وأكثر النَّاس إنَّما يُطعِم أهلَه الخبز، فإن جعلتم هذا معاوضةً كان ربًا ظاهرًا، وإن لم تجعلوه معاوضةً فالحبُّ ثابتٌ لها في ذمَّته، ولم تَعْتَضْ عنه، فلا تبرأ ذمَّته منه إلا بإسقاطها وإبرائها، فإذا لم تُبرِئْه طالبتْه بالحبِّ مدَّةً طويلةً مع إنفاقه عليها كلَّ يومٍ حاجتَها من الخبز والأُدْمِ، وإن مات أحدهما كان الحبُّ دَينًا له أو عليه، يؤخذ من التَّركة، مع سعة الإنفاق عليها كلَّ يومٍ. ومعلومٌ أنَّ الشَّريعة الكاملة المشتملة على العدل والحكمة والمصلحة تأبى ذلك كلَّ الإباء، وتدفعه كلَّ الدَّفع، كما يدفعه العقل والعرف.
ولا يمكن أن يقال: إنَّ النَّفقة الَّتي في ذمَّته تَسقُط بالَّذي له عليها من الخبز والأُدْم لوجهين، أحدهما: أنَّه لم يبعه إيَّاها، ولا اقترضها إيّاه منها حتَّى يثبت في ذمَّتها، بل هي معه فيه على حكم الضَّيف لامتناع المعاوضة عن الحبِّ بذلك شرعًا. ولو قُدِّر ثبوته في ذمَّتها لما أمكنت المُقاصَّة لاختلاف الدَّيْنَينِ جنسًا، والمقاصَّة تعتمد اتِّفاقهما. هذا، وإن قيل بأحد الوجهين إنَّه لا يجوز المعاوضة على النَّفقة مطلقًا لا بدراهمَ ولا غيرِها، لأنَّه معاوضةٌ عمَّا لم يَستقرَّ ولم يجب، فإنَّها إنَّما تجب شيئًا فشيئًا، فعنده لا تصحُّ المعاوضة عليها حتَّى تستقرَّ بمضيِّ الزَّمان، فيعاوض عنها كما يعاوض عمَّا هو مستقرٌّ في الذِّمَّة من الدُّيون.
ولمَّا لم يجد بعض أصحاب الشَّافعيِّ من هذا الإشكال مَخْلَصًا قال: الصَّحيح أنَّها إذا أكلتْ سقطتْ نفقتُها. قال الرافعي في «محرَّره»: أولى الوجهين السُّقوط، وصحَّحه النووي لجريان النَّاس عليه في كلِّ عصرٍ ومصرٍ، واكتفاء الزَّوجة به. وقال الرافعي في «الشَّرح الكبير» و «الأوسط»: فيه وجهان، أَقْيَسُهما: أنَّها لا تسقط؛ لأنَّه لم يُوف الواجب وتطوَّع بما ليس بواجبٍ. وصرَّحوا بأنَّ هذين الوجهين في الرَّشيدة الَّتي أذِنَ لها قيِّمُها، فإن لم يأذنْ لها لم تسقُطْ وجهًا واحدًا.
فصل
وفي حديث هند دليلٌ على جواز قول الرَّجل في غريمه ما فيه من العيوب عند شكواه، وأنَّ ذلك ليس بغيبة، ونظير ذلك قول الآخر في خصمه: «يا رسول اللَّه، إنَّه فاجرٌ لا يبالي ما حلف عليه».
وفيه دليلٌ على تفرُّد الأب بنفقة أولاده ولا تُشاركه فيها الأمُّ، وهذا إجماعٌ من العلماء إلا قولٌ شاذٌّ لا يلتفت إليه: إنَّ على الأمِّ من النَّفقةَ بقدر ميراثها، وزعم صاحب هذا القول أنَّه طردَ القياسَ على كلِّ من له ذكرٌ وأنثى في درجةٍ وهما وارثانِ فإنَّ النَّفقة عليهما، كما لو كان له أخٌ وأختٌ، أو أمٌّ وجدٌّ، أو ابنٌ وبنتٌ، فالنَّفقة عليهما على قدر ميراثهما، فكذلك الأب والأمُّ.
والصَّحيح: انفراد العصبة بالنَّفقة، وهذا كلُّه كما ينفرد بها الأب دون الأمِّ بالإنفاق، وهذا هو مقتضى قواعد الشَّرع، فإنَّ العاصب ينفرد بحمل العقل وولاية النِّكاح وولاية الموت والميراث بالولاء. وقد نصَّ الشَّافعيُّ على أنَّه إذا اجتمع أمٌّ وجدٌّ أو أبٌ فالنَّفقة على الجدِّ وحده، وهو إحدى الرِّوايات عن أحمد، وهي الصَّحيحة في الدَّليل.
وكذلك إن اجتمع ابنٌ وبنتٌ، أو أمٌّ وابنٌ، أو بنتٌ وابنُ ابنٍ، فقال الشَّافعيُّ: النَّفقة في هذه المسائل الثَّلاث على الابن لأنَّه العصبة، وهو إحدى الرِّوايات عن أحمد. والثَّانية أنَّها على قدر الميراث في المسائل الثَّلاث. وقال أبو حنيفة: النَّفقة في مسألة الابن والبنت عليهما نصفان لتساويهما في القرب، وفي مسألة بنتٍ وابن ابنٍ: النَّفقة على البنت لأنَّها أقرب. وفي مسألة أمٍّ وبنتٍ: على الأمِّ الرُّبعُ والباقي على البنت، وهو قول أحمد، وقال الشَّافعيُّ: تنفرد بها البنت؛ لأنَّها تكون عصبةً مع أخيها. والصَّحيح: انفراد العصبة بالإنفاق؛ لأنَّه الوارث المطلق.
وفيه دليلٌ على أنَّ نفقة الزَّوجة والأقارب مقدَّرةٌ بالكفاية، وأنَّ ذلك بالمعروف، وأنَّ لمن له النَّفقة أن يأخذها بنفسه إذا منعه إيَّاها من هي عليه.
وقد احتُجَّ به على جواز الحكم على الغائب. ولا دليلَ فيه؛ لأنَّ أبا سفيان كان حاضرًا في البلد لم يكن مسافرًا، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لم يسألها البيِّنة، ولا يُعطى المدَّعي بمجرَّد دعواه، وإنَّما كان هذا فتوى منه - صلى الله عليه وسلم -.
وقد احتُجَّ به على مسألة الظَّفر، وأنَّ للإنسان أن يأخذ من مال غريمه إذا ظَفِرَ به بقدر حقِّه الذي جَحدَه إيَّاه. ولا يدلُّ لثلاثة أوجهٍ:
أحدها: أنَّ سبب الحقِّ هاهنا ظاهرٌ وهو الزَّوجيَّة، فلا يكون الأخذ خيانةً في الظَّاهر، فلا يتناوله قول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «أدِّ الأمانةَ إلى من ائتمنَك، ولا تَخُنْ من خانَك». ولهذا نصَّ أحمد على المسألتين مفرِّقًا بينهما، فمنعَ من الأخذ في مسألة الظَّفر، وجَوَّز للزَّوجة الأخذَ، وعمِلَ بكلا الحديثين.
الثَّاني: أنَّه يَشُقُّ على الزَّوجة أن ترفعه إلى الحاكم، فيُلزِمه بالإنفاق أو الفراق، وفي ذلك مضرَّةٌ عليها مع تمكُّنها من أخذ حقِّها.
الثَّالث: أنَّ حقَّها يتجدَّد كلَّ يومٍ، فليس هو حقًّا واحدًا مستقرًّا يمكن أن تستدين عليه أو ترفعه إلى الحاكم، بخلاف حقِّ المدين.
فصل
وقد احتُجَّ بقصَّة هند هذه على أنَّ نفقة الزَّوجة تسقط بمضيِّ الزَّمان؛ لأنَّه لم يُمكِّنها من أخْذِ ما مضى لها من قدر الكفاية مع قولها: إنَّه لا يُعطيها ما يكفيها. ولا دليلَ فيها؛ لأنَّها لم تَدَّعِ به ولا طلبتْه، وإنَّما استفتتْه: هل تأخذ في المستقبل ما يكفيها؟ فأفتاها بذلك.
وبعدُ، فقد اختلف النَّاس في نفقة الزَّوجات والأقارب، هل يسقطان بمضيِّ الزَّمان كلاهما، أو لا يسقطان، أو تسقط نفقة الأقارب دون الزَّوجات؟ على ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: أنَّهما يسقطان بمضيِّ الزَّمان، وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الرِّوايتين عن أحمد.
والثَّاني: أنَّهما لا يسقطان إذا كان القريب طفلًا، وهذا وجهٌ للشَّافعيَّة.
والثَّالث: تسقط نفقة القريب دون نفقة الزَّوجة، وهذا هو المشهور من مذهب الشَّافعيِّ وأحمد ومالك.
ثمَّ الذين أسقطوها بمضيِّ الزَّمان منهم من قال: إذا كان الحاكم قد فرضها لم تسقط، وهذا قول بعض الشَّافعيَّة والحنابلة. ومنهم من قال: لا يُؤثِّر فرض الحاكم في وجوبها شيئًا إذا سقطت بمضيِّ الزَّمان. والَّذي ذكره أبو البركات في «محرَّره» الفرق بين نفقة الزَّوجة ونفقة القريب في ذلك، فقال: وإذا غاب مدَّةً ولم ينفق لزِمَه نفقة الماضي، وعنه: لا يلزمه إلا أن يكون الحاكم قد فرضَها. وأمَّا نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى وإن فُرِضت، إلا أن يستدان عليه بإذن الحاكم.
وهذا هو الصَّواب، وأنَّه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب لما مضى من الزَّمان نقلًا وتوجيهًا:
أمَّا النَّقل، فإنَّه لا يُعرف عن أحمد ولا عن قدماء أصحابه استقرارُ نفقة القريب بمضيِّ الزَّمان إذا فرضها الحاكم، ولا عن الشَّافعيِّ وقدماء أصحابه والمحقِّقين لمذهبه منهم، كصاحب «المهذَّب» و «الحاوي» و «الشَّامل» و «النِّهاية» و «التَّهذيب» و «البيان» و «الذَّخائر». وليس في هذه الكتب إلا السُّقوط بدون استثناء فرضٍ، وإنَّما يوجد استقرارها إذا فرضها الحاكم في «الوسيط» و «الوجيز» و «شرح الرافعي» وفروعه. وقد صرَّح نصر المقدسي في «تهذيبه» والمحاملي في «العدَّة» ومحمد بن عثمان في «التَّمهيد» والبندنيجي في «المعتمد» بأنَّها لا تستقرُّ ولو فرضها القاضي، وعلَّلوا السُّقوط بأنَّها تجب على وجه المواساة لإحياء النَّفس، ولهذا لا تجب مع يسار المنفق عليه. وهذا التَّعليل يوجب سقوطها، فُرِضَتْ أو لم تُفرض.
قال أبو المعالي: وممَّا يدلُّ على ذلك أنَّ نفقة القريب إمتاعٌ لا تمليكٌ، وما لا يجب فيه التَّمليك وانثنَى إلى الكفاية استحال مصيره دَينًا في الذِّمَّة. واستبعد لهذا التَّعليل قول من يقول: إنَّ نفقة الصَّغير تستقرُّ بمضيِّ الزَّمان، وبالغ في تضعيفه من جهة أنَّ إيجاب الكفاية مع إيجاب عوض ما مضى متناقضٌ، ثمَّ اعتذر عن تقررها في صورة الحمل على الأصحِّ، إذا قلنا: إنَّ النَّفقة له بأنَّ الحامل مستحقَّةٌ لها ومنتفعةٌ بها فهي كنفقة الزَّوجة. قال: ولهذا قلنا: تتقدَّر، ثمَّ قال: هذا في الحمل والولد الصَّغير، أمَّا نفقة غيرهما فلا تصير دينًا أصلًا. انتهى.
وهذا الذي قاله هؤلاء هو الصَّواب، فإنَّ في تصوُّر فرْضِ الحاكم نظرًا؛ لأنَّه إمَّا أن يعتقد سقوطها بمضيِّ الزَّمان أو لا، فإن كان يعتقده لم يَسَعْ له الحكمُ بخلافه، وإلزامُ ما يعتقد أنَّه غير لازمٍ، وإن كان لا يعتقد سقوطها مع أنَّه لا يعرف به قائلٌ إلا في الطِّفل الصَّغير على وجهٍ لأصحاب الشَّافعيِّ، فإمَّا أن يعني بالفرض: الإيجابَ، أو إثباتَ الواجب، أو تقديرَه، أو أمرًا رابعًا. فإن أُريد به الإيجاب فهو تحصيل الحاصل ولا أثرَ لفرضه، وكذلك إن أُريد به إثبات الواجب ففرضه وعدمه سِيَّانِ، وإن أُريد به تقدير الواجب فالتَّقدير إنَّما يؤثِّر في صفة الواجب من الزِّيادة والنُّقصان لا في سقوطه وثبوته، فلا أثرَ لفرضه في الوجوب البتَّةَ. هذا مع ما في التَّقدير من مصادمة الأدلَّة الَّتي تقدَّمت على أنَّ الواجب النَّفقة بالمعروف، فيُطعِمهم ممَّا يأكل ويكسوهم ممَّا يلبس. وإن أريد به أمرٌ رابعٌ فلا بدَّ من بيانه لننظر فيه.
فإن قيل: الأمر الرَّابع المراد هو عدم السُّقوط بمضيِّ الزَّمان، فهذا هو محلُّ الحكم، وهو الذي أثَّر فيه حكم الحاكم وتعلَّق به.
قيل: فكيف يمكن أن يعتقد السُّقوط ثمَّ يُلزِم ويقضي بخلافه؟ وإن اعتقد عدم السُّقوط فخلاف الإجماع، ومعلومٌ أنَّ حكم الحاكم لا يُزِيل الشَّيء عن صفته، فإذا كانت صفة هذا الواجب سقوطه بمضيِّ الزَّمان شرعًا لم يُزِلْه حكم الحاكم عن صفته.
فإن قيل: بقي قسمٌ آخر، وهو أن يعتقد الحاكم السُّقوطَ بمضيِّ الزَّمان ما لم يُفرَض، فإن فُرِضت استقرَّت، فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا بنفس مضيِّ الزَّمان.
قيل: هذا لا يُجدِي شيئًا، فإنَّه إذا اعتقد سقوطها بمضيِّ الزَّمان، وأنَّ هذا هو الحقُّ والشَّرع، لم يَجُزْ له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم ثبوته، وما هذا إلا بمثابة ما لو ترافع إليه مضطرٌّ وصاحبُ طعامٍ غير مضطرٍّ، فقضي به للمضطرِّ بعوضه، فلم يتَّفق أخذُه حتَّى زال الاضطرار، ولم يعط صاحبه العوض، أنَّه يُلزِمه بالعوض ويُلزِم صاحب الطَّعام ببذله له، والقريب يستحقُّ النَّفقة لإحياء مهجته، فإذا مضى زمن الوجوب حصل مقصود الشَّارع من إحيائه، فلا فائدة في الرُّجوع بما فات من سبب الإحياء ووسيلته مع حصول المقصود والاستغناء عن السَّبب بسببٍ آخر.
فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بنفقة الزَّوجة، فإنَّها تستقرُّ بمضيِّ الزَّمان ولو لم تُفرض، مع حصول هذا المعنى الذي ذكرتموه بعينه.
قيل: النَّقض لا بدَّ أن يكون بمعلوم الحكم بالنَّصِّ أو الإجماع، وسقوط نفقة الزَّوجة بمضيِّ الزَّمان مسألة نزاعٍ، فأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ يُسقِطانها، والشَّافعيُّ وأحمد في الرِّواية الأخرى لا يُسقِطانها. والَّذين أسقطوها فرَّقوا بينها وبين نفقة القريب بفروقٍ:
أحدها: أنَّ نفقة القريب صلةٌ.
الثَّاني: أنَّ نفقة الزَّوجة تجب مع اليسار والإعسار، بخلاف نفقة القريب.
الثَّالث: أنَّ نفقة الزَّوجة تجب مع استغنائها بمالها، ونفقة القريب لا تجب إلا مع إعساره وحاجته.
الرَّابع: أنَّ الصَّحابة أوجبوا للزَّوجة نفقة ما مضى، ولا يُعرف عن أحدٍ منهم قطُّ أنَّه أوجب للقريب نفقةَ ما مضى، فصحَّ عن عمر - رضي الله عنه - أنَّه كتب إلى أمراء الأجناد في رجالٍ غابوا عن نسائهم، فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلِّقوان فإن طلَّقوا بعثوا بنفقة ما مضى، ولم يخالف عمرَ في ذلك مخالفٌ منهم. قال ابن المنذر: هذه نفقةٌ وجبت بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها.
قال المسقطون: قد شكت هند إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ أبا سفيان لا يعطيها كفايتها، فأباح لها أن تأخذ في المستقبل قدرَ الكفاية، ولم يُجوِّز لها أخْذَ ما مضى.
وقولكم: إنَّها نفقة معاوضةٍ، فالمعاوضة إنَّما هي بالصَّداق، وإنَّما النَّفقة لكونها في حبسه، فهي عانيةٌ عنده كالأسير، فهي من جملة عياله، ونفقتها مواساةٌ، وإلَّا فكلٌّ من الزَّوجين يحصل له من الاستمتاع مثل ما يحصل للآخر، وقد عاوضها على المهر، فإذا استغنتْ عن نفقة ما مضى فلا وجهَ لإلزام الزَّوج به. والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - جعل نفقة الزَّوجة كنفقة القريب بالمعروف وكنفقة الرَّقيق، فالأنواع الثَّلاثة إنَّما وجبت بالمعروف مواساةً لإحياء نفسِ من هو في ملكه وحبسه، ومن بينه وبينه رحمٌ وقرابةٌ، فإذا استغنى عنها بمضيِّ الزَّمان فلا وجه لإلزام الزَّوج بها، وأيُّ معروفٍ في إلزامه نفقتَه لما مضى وحبسِه على ذلك والتَّضييقِ عليه وتعذيبِه بطول الحبس، وتعريضِ الزَّوجة لقضاء أوطارِها من الدُّخول والخروج وعِشْرة الأخدان بانقطاع زوجها عنها وغيبة نظره عليها كما هو الواقع؟ وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا اللَّه، حتَّى إنَّ الفروج لَتَعِجُّ إلى الله من حَبْسِ حُماتِها ومن يصونها عنها، وتسيُّبِها في أوطارها. ومعاذَ الله أن يأتي شرع الله بهذا الفساد الذي قد استطار شرارُه واستَعَرتْ ناره.
وإنَّما أمر عمر بن الخطَّاب الأزواج إذا طلَّقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى، ولم يأمرهم إذا قَدِموا أن يفرضوا نفقة ما مضى، ولا يُعرف ذلك عن صحابيٍّ البتَّةَ. ولا يلزم من الإلزام بالنَّفقة الماضية بعد الطَّلاق وانقطاعِها بالكلِّيَّة الإلزامُ بها إذا عاد الزَّوج إلى النَّفقة والإقامة، واستقبل الزَّوجة بكلِّ ما تحتاج إليه، فاعتبارُ أحدِهما بالآخر غير صحيحٍ. ونفقة الزَّوجة تجب يومًا بيوم، فهي كنفقة القريب، وما مضى فقد استغنتْ عنه بمضيِّ وقته، فلا وجهَ لإلزام الزَّوج به، وذلك منشأ العداوة والبغضاء بين الزَّوجين، وهو ضدُّ ما جعله الله بينهما من المودَّة والرَّحمة. وهذا القول هو الصَّحيح المختار الذي لا تقتضي الشَّريعةُ غيرَه. وقد صرَّح أصحاب الشَّافعيِّ بأنَّ كسوة الزَّوجة وسكنها يَسقُطان بمضيِّ الزَّمان إذا قيل: إنَّهما إمتاعٌ لا تمليكٌ، فإنَّ لهم في ذلك وجهين.
فصل
وأمَّا فرض الدَّراهم، فلا أصلَ له في كتاب الله تعالى، ولا سنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحدٍ من الصَّحابة البتَّةَ، ولا التَّابعين ولا تابعيهم، ولا نصَّ عليه أحدٌ من الأئمَّة الأربعة ولا غيرهم من أئمَّة الإسلام. وهذه كتب الآثار والسُّنن وكلام الأئمَّة بين أظهرنا، فأَوجِدُونا مَن ذكر فرض الدَّراهم.
والله سبحانه أوجب نفقة الأقارب والزَّوجات والرَّقيق بالمعروف، وليس من المعروف فرضُ الدَّراهم، بل المعروف الذي نصَّ عليه صاحب الشَّرع أن يُطعِمهم ممَّا يأكل ويكسوهم ممَّا يلبس، ليس المعروف سوى هذا. وفرضُ الدَّراهم على المنفق من المنكر.
وليست الدَّراهم من الواجب ولا عوضِه، ولا يصحُّ الاعتياض عمَّا لم يستقرَّ ولم يملك، فإنَّ نفقة الأقارب والزَّوجات تجب يومًا فيومًا، ولو كانت مستقرَّةً لم تصحَّ المعاوضة عنها بغير رضى الزَّوج والقريب، فإنَّ الدَّراهم تُجعل عوضًا عن الواجب الأصليِّ، وهو إمَّا البُرُّ عند الشَّافعيِّ، أو الطَّعام المعتاد عند الجمهور، فكيف يُجبَر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غيرِ رضاه ولا إجبارِ صاحبِ الشَّرع له على ذلك؟ فهذا مخالفٌ لقواعد الشَّرع ونصوص الأئمَّة ومصالح العباد، ولكن إن اتَّفق المُنفِق والمُنفَق عليه على ذلك جاز باتِّفاقهما.
هذا مع أنَّه في جواز اعتياض الزَّوجة عن النَّفقة الواجبة لها نزاعٌ معروفٌ في مذهب الشَّافعيِّ وغيره، فقيل: لا تعتاض؛ لأنَّ نفقتها طعامٌ ثبت في الذِّمَّة عوضًا، فلا تعتاض عنه قبل القبض كالمُسلَم فيه، وعلى هذا فلا يجوز الاعتياض لا بدراهم ولا ثيابٍ ولا شيءٍ البتَّةَ. وقيل: تعتاض بغير الخبز والدَّقيق؛ فإنَّ الاعتياض بهما ربًا، هذا إذا كان الاعتياض عن الماضي، فإن كان عن المستقبل لم يصحَّ عندهم وجهًا واحدًا؛ لأنَّها بصدد السُّقوط، فلا يُعلَم استقرارها.
زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (٦/ ٧٩ - ١٠٥)